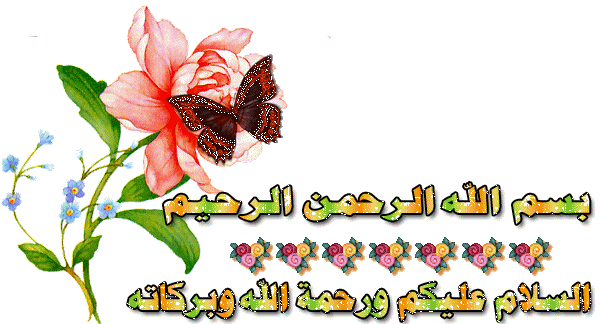
شيمة عنقرية
البدو واللي بالقرى نازلينا** كلٍ عطاه الله من هبَّة الريح
ناصر الحميضي : جريدة الرياض
الشيمة: معناها الحرص على الكرامة وإبقائها سواء كرامته أو كرامة الآخرين، وهي التي تظهر في أساليب وتصرفات عديدة كالعزوف وترك الشيء الذي كان الشخص يريده ويرغب فيه من قبل ومتعلق قلبه به ويرجو الحصول عليه، ولكنه تركه بعد أن عافته نفسه لسبب وجيه يدعو لحفظ الكرامة، فيقول والحالة تلك: (شامت نفسي) عن هذا الشيء الذي يوردني المهانة، وكأنه يقول: أقفلت نفسي أبواب الرغبة فيه، فالنفس الكريمة تشوم عصبا عن صاحبها وإرادته وعواطفه ومشاعره وأحاسيسه.
كما أن الشيمة تعني الامتناع عن قول أو فعل يسبب للقائل أو الفاعل نقصاً أو يجلب له منقصة، فتشوم الرجال عن قول الألفاظ غير المقبولة وعن كل مشين وعن العذاريب، كما قال أحد الشعراء :
اللي يبي العزة يعزز مكانه
ويشوم عن كل العذاريب ويتوب
ودرج بين الناس مسمى الشيمة ومصطلح الشيمة عموماً وهي معروفة كخصلة نبيلة طيبة، ولها نماذج كثيرة وعديدة من حيث التطبيق وتتسع لكل معاني الرفعة والترفُّع، فالعرب فيهم هذه الخصلة الطيبة، وكل منهم يحمل في نفسه تلك الصفة وبذورها، ولا يقبل أن يهان هو، أو يهان له طرف أو جار أو جوار، كما لا يقبل أن يصدر منه ما يسيء لأحد، وهذا ثابت في العموم و ويعرف عبر التاريخ العربي أيضا، وهي من مكارم الأخلاق.
وقد اشتهر في حديث المجتمع وقصصهم وترددت في أشعارهم شيمة لها شاهد محدد وموقف قد سطره الموقف بقصيدة من صاحب الشيمة نفسه، ولأن صاحبها يقال له العنقري فقد قيل (شيمة عنقرية) نسبة إلى صاحبها بداح العنقري بحسب الروايات الشفوية والمكتوبة.
وقصة بداح العنقري وشيمته وهو الشاعر والفارس الشجاع، تبدأ من الحب وتنتهي بالكره، فهو كغيره ممن يعشق الجمال ويميل إليه، ويرغبه كلما كان ذلك الجمال كمالا وقيمة ورفعة، ويرغب فيه كلما أضاف له شيئا نافعاً وشفى نفسه الطامعة فيه، لكن بشرط ألا يكون على حساب كرامته أو شيء مما يعتز به.
لقد تعلق قلبه بفتاة من البادية وقت نزول أهلها قريباً من الحضر، وهذا النزول وقرب البوادي من الحواضر، يحصل في فصل الصيف حيث شح الموارد وقلة الماء، وانعدام الكلأ، وهذا التعلق لم يتعد حاجزه وهو أمر طبيعي أن يتعلق حضري ببدوية أو بدوي بحضرية أعجب بها، سنة الحياة وطبيعة البشر، وما مسمى بدوي وحضري إلا أسلوب حياة لا تفريقاً في غيره والكل لحمة واحدة وجسد، وكما تختلف عادات سكان كل بلد عن البلد الآخر وكذلك أسلوب حياتهم، فإن البوادي لهم أسلوبهم من حيث التنقل وممارسة أعمال ذات صلة بالإبل والرعي وما يتطلبه كل ذلك من جهد ومواصلة نزول ورحيل لا حياة استقرار، وكذلك للحضر أساليبهم ومشقتهم في الفلاحة والتعب مع الأرض والزرع، والكل يسعى في تأمين لقمة العيش وتأمين حياة كريمة له ولمجتمعه ولعل حياة البادية أكثر شدة وغلظة كما أنهه يعتاد ساكنها على تحمل المصاعب أكثر من غيرهم.
بداح العنقري وهو الحضري، قيل أنه كان يعمل في البيع والشراء، وأنه يتعامل كثيرا مع أهل البادية كعادة التجار الذين يبيعون لهم ويشترون منهم وقيل أنه الأمير، وهذا لا يمنع من كونه أميرا وتاجرا أيضا فمعظم الأمراء في كل وقت لهم نشاطهم الإداري والتجاري في آن واحد بل ونشاطهم الزراعي أو الرعوي وهذا لا غرابة فيه، وبالتالي يعرفهم جيداً ويعرفونه.
وكل هذا لا يهمنا الآن، وما يهم هو أنه قد تعلق بالفتاة إما برؤيتها أو بالسماع عنها، فزاد الوله حتى ملك شغاف قلبه وكل إحساسه، فلما انتهى الصيف وبدأت ترحل قوافل البوادي إلى مواطن الترحال والتنقل قرر أن يخطب الفتاة ليتزوجها، فتبعهم إلى مكان نزولهم وافدا عليهم كضيف ليس بمستغرب ووجه معروف له تعاملاته مع الجميع فرحبوا به، ولكن وفادته تلك مختلفة فكان له مطلب محدد أبداه لوالد الفتاة مبينا رغبته في الزواج من ابنتهم ، ولكن الوالد عندما شاورها في هذا الأمر أظهر مكنون قلبها في عدم رغبتها لكونه حضري، وأنه لا يتصف بالشجاعة التي ترغبها في فارس المستقبل، وقالت أن ما تراه منه هو جمال نظرة أو على حد تعبيرها الذي يروى ( زين الحضر زين تصفيح).
وهذه الكلمات سمعها العنقري لأن بيوت الشعر لا تحجب الصوت ويمكن سماع الهمس فيها.
ورغم أن العنقري يجيد ركوب الخيل ورأت منه السباق كما هي عادة أهل الخيل في وقت نزولهم في المكان يتسابقون وظهوره بمظهر الفارس حقيقة، إلا أنها لم تقنعها رؤيته في سباق سلمي ليس حربي، وكما قالت بأنه [ زين تصفيح ] بمعنى جمال صورة وثياب لا حقيقة وراءها في حالة نشوب قتال أو حرب وغزو طارئ.
ومن تلك اللحظة حملت نفس بداح العنقري بذور الشيمة التي نحن بصددها، وانقلب الحب والتعلق بها إلى عكسه، لأنه يعرف نفسه أكثر منها ويقدر ذاته و مكانتها، قيل عن قصته أقوال كثيرة، وما يهمنا هو النهاية.
لقد كانت إقامته تلك مؤقتة، فقد انتهى مطلبه إلى الرفض واستقر رأيه على العودة، وانزاح ما في نفسه، وكان الأمل المنتظر قد حطمته الكلمات، بقسوتها وعدم إنصافها، وما أقسى التحطيم الصادر ممن تعلق الأمل به، ذلك لأنها اتخذت أسلوب التعميم، وهذا لا ينبغي، فلا لأفراد الحضر ولا البدو صفات واحدة محددة حكرا عليهم، بل كل فرد له ما يتميز به، والتعميم هو القشة التي قصمت ظهر الشوق والتعلق والمحبة، وحولت جذوة نار قلبه إلى رماد بارد وليس حاراً كما كان من قبل.
إنه بانتظار الرحيل عبر طريق العودة، يخفي جراحا لا تزال ندية يقطر منها الأسى، وهواجس تعاظمت في نفسه، فما أقسى رمي الكلمات بلا حساب لكرامة النفوس الكريمة.
ولعلها من الصدف التي جعلت للقصة عمرا يمتد، وللحكاية نفساً يطول إلى أن تصبح بعض عباراتها مثلاً، فقد أغارت موجة غازية على قومها وهم في منازلهم كما يحصل عادة في زمن مضى والعنقري ضيفا لا يزال في مسرح العمليات، والاعتداء ليس فيه عدل ولا مراعاة فيه لمبدأ، وإنما هو ظلم والقبائل في السابق تظلم بعضها بعضاً.
فكانت القبيلة بكل فرسانها في مواجهة حية مع الموقف، ولكن غلبت كثرة الغزاة شجاعة المدافعين، وكان بداح العنقري من ضمن المدافعين، ومن المعروف أن من قتل فارساً جاء بعنان فرسه، وهو شاهد على أنه سبق إليه وقابله، فجاء الفرسان بعد رد الاعتداء وجمع الغنائم الكثيرة، وكل يفخر بفعله ويذكر أيضا شراسة وقوة وكثرة أولئك الذين شنوا غارة عليهم، ولكن بداح العنقري جاء ومعه أعنة الفرسان المهزومين بقتل أو فرار، والقاها على شيخ القبيلة والفتاة ترى وتبصر وتميز وهي ابنة الشيخ التي رفضته مدعية أنه ليس فارس ميدان ولا فارس أحلامها.
وقيل أنه كان يحمل الرمح حتى انكسر في نصف المعركة فتناول السيف، ولطول المدة وشدة قبضه عليه يبست يده على مقبضه فلم يفك إلا بالدهن الحار.
وتقديم الرمح في القصيدة على السيف له دلالات أخرى تختلف عن تقديم السيف على الرمح منها أنه بدا المقاومة والدفاع فاتحا ثغرة في صفوف الغازين وتفصيلات لا تضيف شيئا لهذه القصة.
فسأل الشيخ فرسان القبيلة عن فعلهم وعن الأعنة، فلم يكن معهم ما يفي بمراده ليس معهم سوى القليل أو ما معهم شيء، وسمعت الفتاة ما يدور وكانت تظن من سماع أقوالهم ومفاخرهم أنهم المدافعون بحق، لكن الأعنة الكثيرة التي جاء بها بداح العنقري بينهم خيبت ظنها وحطمت أملها، لما تكنه في نفسها وحسرة من تسرع حكمها عليه، وكأنها تقول لهم بلسان حالها هذا هو الفارس وهذه مأساة تنتظرني.
بينت الفتاة بعد هذا الموقف رغبتها في قبول الزواج من بداح العنقري معلنة فخرها به وكأنها بهذا العمل تنسيه عبارات التجريح السابقة، لكنه قد انتهى من قرار العودة إلى دياره وقد شامت نفسه وأعلنها صراحة بأنه لا رغبة له فيها (شيمة عنقري) لا رجعة فيها، فالموقف محسوم من لحظة انغراس خنجر قولها الأول غير الموزون محدثاً له جرحا لا تخيطه المعاذير.
(والجروح اللي وسيعه ما يخيط شقها)
وقال قصيدته المشهورة منها:
وراك تزهد ياريش العين فينا
تقول خيال القرى زين تصفيح
الله لحد يا ما غزينا وجينا
وياما ركبنا حاميات المشاويح
حتى قال:
الطيب ما هو بس للظاعنينا
مقسمن بين الوجيه المفاليح
البدو واللي بالقرى نازلينا
كلن عطاه الله من هبَّة الريح
والقصيدة أطول من هذا وفي نهايتها بعض الغزل مما يدل على أن الشيمة فوق كل اعتبار عاطفي وتداس على القلوب أحياناً عندما تقود صاحبها للتنازل عن الكرامة.
ونحن نوردها هنا مع الأخذ في الاعتبار تعدد الروايات وتبدل تفاصيلها مع التوافق في مضمونها ونهايتها وكذلك القصيدة، نوردها لا لنفخر بشخص هو العنقري أو غيره، وإن كان في الواقع فعله مفخرة الكل يعتز به، كذلك لانعتب على تلك الفتاة، فلا شأن لنا بشخوص القصة ولكن نوردها لكي تكون درساً لنا فلا نحكم على الأفراد حكما جائراً، ولا يكون لخلفيات سابقة في نفوسنا تحكما في عقولنا بحيث يغيب الإنصاف، كما أن الفضائل والخصال بكل أنواعها ليست حكراً على فئة دون أخرى، ولا محصورة في زمان أو مكان.